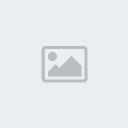هل من الممكن أن تجدد الذاكرة حزنا ووجعها ونزفها؟؟ الإجابة وبلا تردد نعم، فلقد عادت إلى الواجهة في الذاكرة الفلسطينية بقوة بعض تفاصيل ومشاهد النكبة عام 1948،عبر مسلسلين تلفزيونيين هما التغريبة الفلسطينية للمخرج السوري حاتم علي، ومسلسل " عائد إلى حيفا " للمخرج الفلسطيني باسل الخطيب.
ورغم تشابه المسلسلين في بعض الأفكار والحوادث إلا أن مسلسل ( عائد إلى حيفا ) والذي يحمل اسم ومضمون رواية للأديب الراحل غسان كنفاني أعاد إلى الذاكرة أيضا سيرة حافلة لأصل الرواية التي احتلت في وجدان الفلسطينيين مكانا متميزا منذ عدة عقود؟؟ فيا ترى ماذا تحكي هذه الرواية؟؟ وكيف استطاعت أن تحافظ على وهجها رغم مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور الطبعة الأولى منها؟
• هل من جديدْ؟
البحث عن الجديد سؤال يشغل بال الكثيرين، وقد ألح على قلمي حين هممت بالكتابة عن هذه الرواية تحديدا، فما هو الجديد الذي سأقدمه للقارئ عن هذه الرواية بعد عشرات المقالات والدراسات والمؤلفات عن هذه الرواية بشكل خاص، وأدب كنفاني بوجه عام.
السؤال المتكرر للنفس في البحث عن الجديد الذي قد يكون قيدا على القلم في فترات معينة إذا لم يستطع الكاتب أن ينطلق من حصار الأسئلة، ويُضيف جديدا في ختام سطوره.
من هنا رأيت أن إطلالة متنوعة على الرواية بين الأدب والفن، مع اختصار لبعض المعلومات وجمع بعضها الآخر قد يساعد في تجاوز إشكالية البحث عن الجديد، وتقديم معلومات بشكل كافي للقارئ الذي يبحث عن هوية هذا العمل وأهميته.
• السيرة الذاتية للرواية:
رواية عائد إلى حيفا للأديب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني، سجلت نفسها كأحد أبرز الروايات في الأدب الفلسطيني المعاصر، وكانت من الأعمال التي عززت انطلاقة كاتبها إلى الأفق العالمي كما سنرى، صدرت طبعتها الأولى عام 1969، وقد صدرت عدة طبعات منها داخل فلسطين وخارجها، ولقد وصل عدد الطبعات حتى عام 2001 إلى خمس طبعات باللغة العربية، بالإضافة على ترجمتها إلى عدة لغات كان من بينها، ترجمتها إلى اللغة الروسية عام 1974 عن طريق المترجم السوري د. ماجد علاء الدين، وقيام الباحث الإيراني يوسف عزيزي بترجمتها إلى اللغة الفارسية عام 1991م. بالإضافة إلى عدد من اللغات الأوروبية وهذا يعني أنّ الرواية استطاعت أن تحلق بفكرتها وإبداعها في فضاءات الجغرافيا المختلفة، تنشر القضية وتحكي عن الكارثة وتعمل على تشكيل فهم ووعي عن طبيعة القضية الفلسطينية كما سنرى عند الحديث عن مضمونها.
أمر آخر وهو أن هذه الترجمات ساعدت في تحقيق تواصل بين أدباء العالم ومثقفيها ليس مع فلسطين بعنوانها العريض فحسب بل مع أدق الفسيفساء التي كانت تكون الروح الفلسطينية في وقت حرج ومهم وحساس، حيث تحكي الرواية عن زمن النكبة والنكسة، وعمق الإشكالية التي تعالجها الرواية في مفهوم الوطن والحنين له والعودة إلى ربوعه.
* مضمون الرواية:
قد يكون من الملفت حين البدء في الحديث عن رواية ( عائد إلى حيفا ) أن نذكر أن عدد صفحاتها لا يزيد عن سبعين صفحة من القطع الصغير !! وهذا يولّد حوارا مبكرا في أنّ العمل الأدبي لا يرتبط بالحجم وإنما بالنوع، وأن الروائي يستطيع أن يطيل أو يختصر حسب ما يرى ذلك مناسبا، ومفيدا للعمل الأدبي الذي بين يديه.
يقو الناشر عند تعريفه بالرواية فيقول ( في هذه الرواية، يرسم غسان كنفاني الوعي الجديد الذي بدأ يتبلور بعد هزيمة 67، إنها محاكمة للذات من خلال إعادة النظر في مفهوم العودة ومفهوم الوطن ).
سعيد بطل الحكاية ويمكن أن نقول وجع الحكاية فهذا أدق في الوصف حيث يعود ( سعيد. س ) كما يذكر كنفاني في روايته إلى حيفا مع زوجته صفية بعد عشرين عاما من النكبة حيث التهجير القسري، وحيث تنسى الأم ابنها الرضيع خلدون على سريها في المنزل، وتظل في حالة بحث عن زوجها الذي يقلقها تأخره في ظل الوضع المتوتر في الحرب بين الصهاينة والفلسطينيين، وتجد نفسها بين الناس في الشوارع يجرها سيلهم وهي لا تدري على أين يسير بها، وهو ما جرى بصورة مختلفة قليلا مع زوجها. حيث وجد نفسه يسير اضطراريا نحو الميناء غير قادر على الرجوع إلى المنزل والبحث عن زوجته وابنته.
هذه الأحداث يسردها الراوي بطريقة فنية متميزة حيث تأتي في إطار استذكار مشوق ومحزن من قبل ( سعيد ) وهو في طريقه إلى حيفا مع زوجته، حيث يعودان لزيارتها بعد سقوط الضفة الغربية وغزة بأيدي الصهاينة بعد نكسة حزيران 1967 وسماح قوات الاحتلال للفلسطينيين في الضفة بالتجول بحكم أن المناطق كلها هي تابعة لدولة إسرائيل.
وهو عبر هذه المفارقة يجدها فرصة كي يرى منزله وذكرياته التي هناك، ويكون في شوق ولهفة أكبر مع زوجته إلى معرفة المصير الغامض الذي حل بابنهم الرضيع قبل عشرين عاما. والذي لم تفلح جهودهم الأخرى في معرفة ذلك المصير الغامض.
وفي هذا السياق يجيء تعريف الناشر مرة أخرى بالرواية حين يقول ( سعيد س. العائد إلى مدينته التي ترك فيها طفله يكتشف أن الإنسان هو قضية، وأن فلسطين ليست استعادة للذكريات، بل هي صناعة للمستقبل ).
ويأتي هذا بعد أن يصل سعيد مع زوجته صفية إلى منزلهما في حيفا، ليجدا ميريام اليهودية وقد سكنت في البيت مع زوجها إيفرات كوشن بعد أيام قليلة على ترك سعيد للمدينة، حيث صار البيت تحت تصرف هيئة أملاك الغائبين، ويجد ميريام وكوشن إغراء مع البيت، طفل رضيع يسمح لهما بتبنيه إذا وافقا على السكن في المنزل!
وهكذا يضيع البيت والابن والوطن كذلك، وتضيع 20 سنة من سعيد وصفية وهما على أمل اللقاء بخلدون، الذي يلتقيانه في نفس البيت ولكن وقد تربى عند هذه العائلة اليهودية وصار جنديا في دفاع الجيش الإسرائيلي، وحمل من يوم ضياع حيفا اسم " دوف "، وكل هذه الدلالات تكشف تناقضا غريبا ومبدعا في الرواية حين يرفض دوف العودة مع والديه، ويصر على ما تربى عليه عند ميريام، أمام صورة الابن الثاني خالد والذي بقي في المنزل وهو يصر دائما على حمل السلاح دفاعا عن الوطن. ليقول سعيد بعد ذلك بكل وضوح: (كنت أفتش عن فلسطين الحقيقية، فلسطين التي هي أكثر من ذاكرة، أكثر من ريشسة طاووس، أكثر من ولد، أكثر من خرابيش قلم رصاص على جدار السلم).
ويعترف أن الوطن عند ابنه خالد صار هو المستقبل رغم أن هذا الأخير لم يعرف حيفا، التي يعرفها والده بكل تفاصيلها ودروبها حتى لو تغيرت أسماء شوارعها إلى العبرية رغما عنها.
في هذه الرواية يغيب الرمز كما يقول الناقد ناهض زقوت (فالمعطى الواقعي الفلسطيني لا يتقبل الرمزية في الإبداع، حيث كان المبدع مشحوناً بالصور والدلالات والتفاصيل والمآسي والمذابح، فكان لا بد من تقديم تلك الشحونات فنياً وإبداعياً، لهذا غاب الرمز ليحل محله تعبير مباشر وقوي عن جوهرية النكبة وتداعياتها).
* الرواية تلفزيونيا:
كان أول ظهور للرواية على الشاشة عام 1982 حين قام المخرج العراقي قاسم حوَل بإخراج فيلم روائي حمل اسم الرواية واستند إلى قصتها.
هذا الظهور التلفزيوني للرواية أضاف إليها بعدا جديدا من الشهرة، وسلط الضوء عليها، وأعطاها مساحة أوسع من الجمهور الذي تعرف على الرواية من هذا العمل التلفزيوني.
أما المسلسل الذي حمل اسم الرواية أيضا كما أسلفنا فهو يحاكي قضية فلسطين في بعدها الإنساني العميق. و يقف المشاهد أمام حالة إنسانية وطنية تراجيدية، حيث تبدأ مع عام النكبة في ذروة أحداثه، ليصور المسلسل رحلة طويلة من التشرد والعذاب والآلام، رحلة يغوص في مخاضها مئات الألوف من الفلسطينيين بعد أن اقتلعوا من ديارهم وحرموا من أهلهم وأرضهم، فالمسلسل يؤرخ ليوميات سقوط حيفا عام 1948 من خلال رصده لمصير عائلة فلسطينية (مأساة المدرس الفلسطيني سعيد وزوجته صفية) حيث التشتت والمعاناة من التهجير والنزوح والتشريد في المخيمات.
ولأن العمل التلفزيوني بحلقاته المتتابعة يحتاج إلى كثير من التفصيلات، فقد تم الاعتماد على قصة كنفاني كأساس للعمل، مع بعض الإضافات والتفصيلات التي لم تكن موجودة في الرواية والتي تم إضافتها لتتناسب مع العمل الدرامي التلفزيوني وأحداثه الكثيرة عبر كاتب سيناريو.
وكنت قد أبديتُ للمخرج باسل الخطيب استغرابي كون الرواية قليلة عدد الصفحات على عكس المسلسل الذي أخذ مساحة زمنية طويلة، فما كان منه إلا أن قال : إن رواية عائد إلى حيفا تمثل قضية الشعب الفلسطيني بكل ما فيها، ومن هنا على حد قول المخرج جاء السيناريو متناسبا مع قصة كاتب الرواية، حيث تتكون أحداثها مما عايشه الشعب الفلسطيني في نكبته وبعد تشرده.
حيفا…مدينة الجرح والحلم:
ظل الوطن الفلسطيني بالنسبة للأدباء والمثقفين والفنانين يمثل القضية الأولى لهم، قضية الوجدان والمصير والهوية، فعاش فيهم رغم أن الكثيرين هجروا عن ربوعه، وأخذت حيفا بما تحمله من خصوصية تاريخية وجمالية جزءا مهما من هذه الأعمال الأدبية والفنية، ومنها فيلم ( حيفا ) للمخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي، ومن أشهر الأعمال الشعرية ديوان ( حيفا في سواد العيون ) للشاعر حسن البحيري.
هذه الأعمال وغيرها الكثير، جعل من هذه المدينة مكانا لأحداث إبداعاته بنزفها وصمودها، ومنهم من جعلها شمسا يدور في فلكها في كثير من أعماله. وقد حملت في مفرداتها حنينا واشتياق إلى الوطن المحتل، وحاولت تهيئة النفوس لاسترداد ما ضاع من أوطان، عبر بث روح الأمل تارة وتذكير الأجيال بالكارثة التي أصابت هذه المدينة عبر الاحتلال.
ولعل مثل هذه الأعمال الفنية والأدبية تشكل في الوقت الحالي إحراجا لأطراف فلسطينية وعربية، تطالب الفلسطينيين أن يقبلوا بالتوطين أينما كانوا، أو العودة للسكن في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن هنا صار لمثل هذه الأعمال أهمية مضاعفة في وقتنا الحاضر، خاصة وهي تبرز المكان في عنوانها ومعظم تفاصيلها لتكون شاهد إثبات أن الوجدان الفلسطيني المسكون بجرح التاريخ وعبق الأجداد وقداسة القضية وعدالتها يستمد روحا مضاعفة في معركته من كل المكونات الموجودة في ساحة المعركة، ثقافية كانت أم فنية أم تاريخية، وهو بهذا يتيح للجميع أن يشارك من خلال موقعه وإمكانياته في معركة العودة لأنها معركة المكان والحق والعدالة والتاريخ.
* كنفاني… عودة هل تكتمل؟
الكاتب والأديب الراحل غسان كنفاني، والذي استشهد في الثامن من تموز عام 1972، عندما فجر الموساد الإسرائيلي سيارته في بيروت، يمثل نموذجا للأديب والسياسي والكاتب، وبالإضافة إلى موهبته وقلمه الإبداعي المتميز فلقد مثل مولد الكاتب في مدينة عكا في عام الإضراب الشهير سنة 1936، وعيشه في يافا ثم اضطراره للنزوح عن وطنه بعد نكبة 1948، كل هذا شكل مخزونا تاريخيا مريرا كان واضحا في كتاباته النثرية من مقالات في الصحف المختلفة التي عمل بها، أو عبر رواياته وقصصه، وأيضا في سطور دراساته المهمة عن أدب المقاومة في فلسطين والأدب الصهيوني.
لقد تفجر القلم عند كنفاني حقيقة حين تفجرت العبوة في سيارته، فحادثة الاغتيال سلطت الضوء على أعماله بشكل أكبر، وكان اغتيال أديب لم يحمل السلاح يوما، مناسبة لنشطاء المقاومة الفلسطينية، للإشارة إلى أن الاغتيالات الإسرائيلية لا تفرق بين سياسي وعسكري وبين صاحب قلم وحامل بندقية مثلما قال الكاتب أسامة العيسة في مقال له عن الأديب الراحل.
وبعد … فالسؤال الذي يكاد يعلو صوته في نهاية هذه الوقفة يتجلى في أمر واحد ألا وهو هل استطاع كنفاني أن يوصل رسالته التي أراد؟
وهل اقتربنا معه إلى العودة، أم ابتعدت بنا السياسة هذه الأيام بعيدا عن شواطئ حيفا ودروبها؟؟
لا شك أن عودة جسدية لم تكتب للأديب الشهيد، غير أنّ وصول روايته إلى هذا المستوى العالي من الاهتمام يشكل عودة روحية على طريق الوطن السليب.